تقتضي الموضوعية التوقف أمام مشهد الرحيل، ليس عن القصر الجمهوري الذي غادره نهار الحادي عشر من فبراير من عام 2011، بل مغادرته للأرض ومن عليها، أن نسأل التاريخ، كما أشار هو نفسه في آخر خطاب له، كيف كان زمن مبارك وما الذي تركه وراءه؟
حين اختار الرئيس السادات الفريق طيار حسني مبارك نائبا له في منتصف سبعينات القرن المنصرم، كان يجذر لشرعية أبطال أكتوبر، وتاليا سيقدر لـ "سيادة النائب" أن يتحمل المسؤولية في وقت كانت الدولة فيه على شفا حفرة من الهاوية بعد اغتيال السادات.
باعترافه لم يكن مبارك يتطلع بعد الحرب إلى منصب قيادي آخر، كانت أحلامه أن يتم تعيينه سفيرا لمصر في لندن، غير أن للقدر تدابيره، وللحياة أقاصيصها وأحاجيها المغايرة لرغبات البشر تارة والمواتية تارة أخرى.
يحسب للرئيس الراحل الأسبق حسني مبارك أنه استلم مصر مجتمعا متوترا في الداخل، وعلاقات مضطربة في الخارج، وحين غادرها مسؤولا كان الكثير قد تغير على نحو إيجابي، وإن ظلت هناك سلبيات كشأن كل بناء بشري.
في الداخل كانت الأوضاع الاقتصادية صعبة، والبنية التحتية مهترئة، إذ لم تكن مصر قد هنأت بأي عوائد حقيقية للانفتاح الاقتصادي الذي بشر به سلفه أنور السادات، عطفا على أن تزايد عدد السكان كان يشكل وحشا يلتهم أي معدلات للتنمية.
أما الأكثر خوفا وهلعا فتمثل في المد الأصولي الإخواني والسلفي، ذاك الذي فتح له السادات الأبواب واسعة في محاولة منه لضرب التيار اليساري، ولم يدرِ وقتها أنه كان يرتكب واحدة من أكبر الأخطاء في تاريخ مصر المعاصرة في النصف قرن الماضي .
خارجيا جاء مبارك والجسور مع العالم العربي مقطوعة، من جراء اتفاقية كامب ديفيد، مما جعل القاهرة معزولة عن محيطها الإقليمي الطبيعي، لا سيما أن جامعة الدول العربية قد نقل مقرها إلى تونس، كنوع من العقاب المباشر للمصريين الذين تجرؤوا على التصالح مع الإسرائيليين.
في هذا الإطار الصعب استهل مبارك رئاسته الأولى الأصعب، لكنه عبر أقل من عقد من الزمان، سوف تتحول مصر من جديد إلى قلب العروبة النابض، والتي يتداعى إليها العرب في محاولة لاستنقاذ المشهد بعد غزو صدام الجنوني للكويت.
قبلها كانت العلاقات العربية – المصرية قد عادت إلى مسارتها ومساقاتها الطبيعية، كما انتصب بيت العرب على ضفاف النيل من جديد، وتحسنت الأوضاع الاقتصادية بدرجة ما، وبدأت مرحلة إعمار جديدة تشمل مدنا جديدة، ومشروعات حديثة في محاولة لتوفير فرص العمل للشباب المصري.
أثبت مبارك مع أزمة احتلال الكويت، وتهديدات صدام لبقية دول الخليج أنه رجل دولة وشريك موثوق في قيادة العالم العربي، وقد كانت مشاركة مصر العسكرية في حرب تحرير الكويت علامة عضوية على رجوع مصر كدرة للتاج العربي من دون أدنى شوفينية.
والشاهد أنه ما بين التسعينات وبداية الألفية الثالثة جرت في المياه المصرية مياه كثيرة سوف تشكل تجربة مبارك، ولعل أهمها قدرته على الحفاظ على السلام الوليد مع إسرائيل، وقد كانت المخاوف من أن تعطل إسرائيل مسار العملية السلمية بعد اغتيال السادات، غير أن مبارك نجح باقتدار في إدارة دفة سفينة المحروسة عابرا بها عباب المشهد المصري المأزوم وقتها.
أكثر من ذلك أثبت مبارك وطنية عالية وغالية، وبالقدر نفسه ظهرت مصر كدولة ويستفالية بالمعنى والمبنى الحقيقيين، لا سيما في ما يخص حفاظها على كل ذرة رمل من ترابها الوطني، ولهذا قاتل مبارك دبلوماسيا من أجل استرجاع طابا، ذلك الشريط الذي لا يتجاوز الكيلومتر، لكنه الرمز لما تمثله الأرض في المفهوم الوطني الراسخ في الأذهان من زمن رمسيس الثاني إلى مبارك.
لم يخضع الرجل أبدا للضغوط الخارجية، فعلى الرغم من علاقته الطيبة مع الجانب الأميركي والتسهيلات التي قدمها بما لا يتعارض مع مصالح الأمن القومي الاستراتيجي المصري، رفض أن يقدم للأميركيين أي قواعد عسكرية سواء على ساحل البحر الأحمر، أو في المتوسط، رغم الإغراءات المالية واللوجستية الأميركية الكبيرة والتي تصعب مقاومتها، واستطاع أن يحافظ على لعبة التوازنات الدولية بمهارة، وإن تعرض في أواخر أيام حكمه لخيانة واضحة من باراك لأوباما الذي أشار المتحدث باسم بيته الأبيض إلى أن على مبارك الرحيل الآن أي الآن، مما جعل الجميع يوقن قولا وفعلا بأن: "المتغطي بالأميركيين عريان".
خاض مبارك معارك عدة على الأرض، أرض الواقع المصري، ولم تكن بطولاته في السماء فقط، وقد كانت معركته مع الإرهاب الأسود واحدة منها، فقد ضرب الإرهاب من جديد مصر أوائل تسعينات القرن الماضي، مما هدد بإهلاك الزرع والضرع، غير أن الرجل وبمساعدة من كبير استخبارييه الراحل اللواء عمر سليمان، والذي سيضحى نائبا له قبل الرحيل الأول، استطاع دحر المعركة وإعادة الوطن إلى سابق عصره من الأمن والاستقرار.
يخيل لأي باحث أو مؤرخ أنه لو لم يكن حسني مبارك المعروف بثباته النفسي والانفعالي كطيار مقاتل، يعلم أين ومتى يوجه "قصفاته الصاروخية"، دون جموح عاطفي أو انفعال وجداني، لكانت الكنانة قد انشغلت بحروب عسكرية لها مبررها عند البعض في الداخل المصري وفي الخارج.
في منتصف ثمانينات القرن المنصرم، جرت المقادير بطرح ليبي من جانب القذافي ذهب فيه إلى التهديد بإغراق المصريين من جنوبهم إلى شمالهم، وذلك عبر قصف السد العالي بالصواريخ السوفيتية التي كان يمتلكها.
هذا الوضع قابله مبارك بالحسم والحزم اللازمين، لكن من غير تزيد أو استغلال ديماغوجي للحدث ليزيد من شعبيته بين المصريين إلى أن هدأت الأوضاع كعادة الجار الليبي.
المشهد الآخر الذي يحسب لسيرة ومسيرة مبارك حدث في يونيو 1995 حين وجهت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية طلقات رصاصها إلى مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقد خلصت أجهزة الاستخبارات المصرية والعالمية إلى أن نظام عمر البشير كان يقف وراء الحادثة وبتشجيع منه.
كان يمكن لمبارك أن يأمر بضربات جوية أو صاروخية، وربما بهجمات للبحرية المصرية على السودان، غير أن الرجل لم ينسق وراء شهوات القلب، وعرف كيف يفرق بين الشعب السوداني الشقيق، وبين قيادة موصومة بالإرهاب، ها هي قاب قوسين أو أدنى من أن تسلم إلى السجان العالمي عبر المحكمة الجنائية الدولية.
على أن مبارك وإن كان عملاقا إلا أن مسيرته لا تخلو من قصور بشري، لكنه للموضوعية قصور لا يقارب بما قدمت يداه، وكأن لسان حاله غداة رحيله عن هذه الفانية يقول:
لا تَلُم كَفّي إِذا السَيفُ نَبا صَحَّ مِنّي العَزمُ وَالدَهرُ أَبى
من بين نقاط الضعف التي شابت عهد مبارك مسيرة الإصلاح والتقدم، نعم هناك ما تحقق، لكن عجلة الإنجاز ربما كانت أبطا من المقبول، وخاصة إذا ما تمت المقارنة مع تجارب دول أخرى، بعضها في آسيا وأخرى في إفريقيا، كسنغافورة، وأندونيسيا، وبقية النمور الآسيوية، التي عرفت معدلات عالية وسريعة من التنمية المستدامة.
من الأخطاء التي تختصم من رصيد عهد مبارك، والتي كانت أحد أسباب نهايته السياسية لا الإنسانية، تعاطيه مع جماعة الإخوان المسلمين، مفضلا المقايضات والمحاصصة على المواجهة الجذرية، وللرجل ولا شك فلسفته في ذلك وحسابات الزمان والمكان، وكذا معطيات العصر، وجلها يغيب عن العوام، لكن عدم الاعتداد بالخبرة الأليمة للسادات الذي قتل على يد من بث فيهم قبلة الحياة، فتح لهم الطريق من جديد للوصول إلى البرلمان وحيازة 88 مقعدا، وتجذير حضورهم الساعي للوصول إلى كابينة القيادة، والتي اكتشف المصريون لاحقا أنهم لا يصلحون لها، وخرجوا إلى الشوارع منادين بسقط حكم المرشد وليس حكم مرسي.
يرحل مبارك وفي رحيله يتذكر البعض أنه كان رجل الفرص الضائعة فقد سنحت له أكثر من فرصة ذهبية ينهي فيها حياته السياسية بكرامة وألق كبيرين، ليذكره التاريخ كرئيس ديمقراطي فضل فكرة تداول السلطة على البقاء مرة و إلى الأبد، ومع ذلك ففي رحيله بدت مصر الطيبة حاضرة.
الذين تابعوا التوجهات الرسمية للدولة المصرية أدركوا مقدار عظمة مصر المؤسساتية من رئاسة الجمهورية إلى المؤسسة العسكرية والبرلمان، من الأزهر الشريف إلى الكنيسة، من الإعلام العام إلى الخاص، هولاء وأولئك الذين سعوا في طريق تكريم الرجل الذي جعل من مصر:"أرض المحيا والممات على حد تعبيره".
أما مشاعر المصريين ودموعهم الغزيزة فقد تبدت من لحظة سماع الخبر الأليم، ونشرت عبر وشائل الإعلام بأشكالها المختلفة مما يعني أنه تحت الجلد المصري ستة آلاف عام من الوفاء والولاء، إلا القليل من الشامتين من أنصار التيارات المتطرفة.
رحل أحد العمالقة المصريين، غفر الله وأسكنه فسيح جناته.
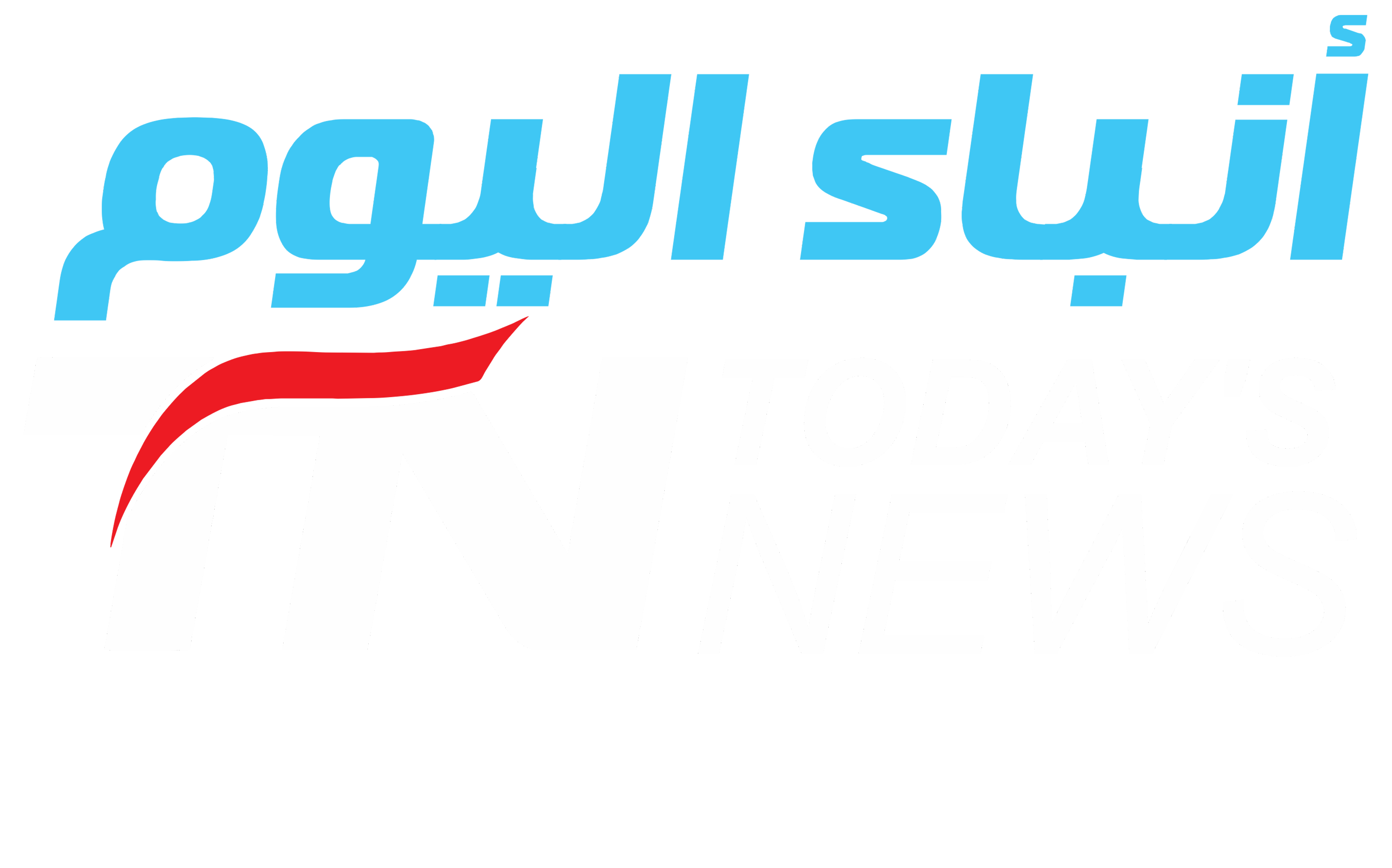


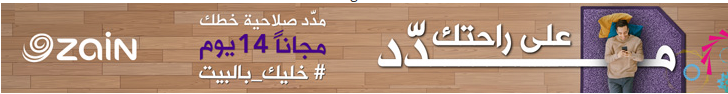


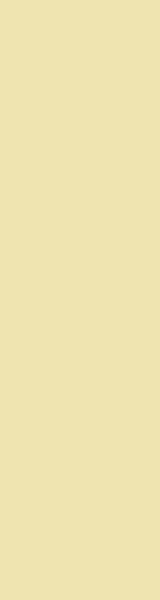












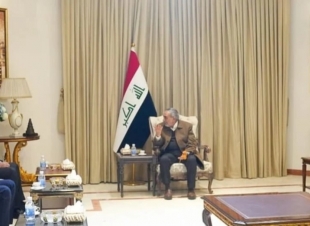






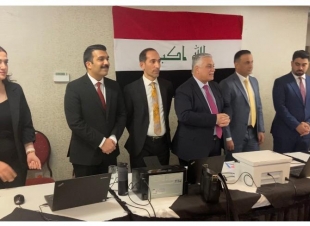


























 ">
"> ">
">




