قد يكون مصطلح «الحروب الثقافيّة» الأكثر تداولاً في الإعلام البريطاني والغربي، عند محاولة الإعلاميين والكتّاب ادعاء العمق في توصيفهم الأجواء التي عاشتها المملكة المتحدّة خلال السنوات الخمس الأخيرة، منذ تصاعد نغمة الغضب تجاه عضويّة بريطانيا في الاتحاد الأوروبيّ، ومن ثمّ تنظيم استفتاء شعبي حول ذلك (يونيو| حزيران 2016)، وما ترتب عليه من نتائج ودراميّات على المسرح السياسي، المحلي والإقليمي، انتهاء بتصديق الطرفين اتفاقاً أنهيت بموجبه علاقة دامت لنصف قرن تقريباً مع غياب شمس يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
هذي الصياغة المتسرعة لرسم أنموذج عن حرب أهليّة تخاض بلا بنادق بين معسكرين متعارضين ليست جديدة بالطبع على الصّحافة البريطانيّة، وكثيراً ما استدعيت لتفسير أحداث تراوحت بين اعتقال الشرطة لمروج مخدرات ذي أصول أفريقيّة، وإرهاب السكاكين (الإسلامي)، ومن استهداف المثليين بالعنف في عربات القطارات إلى إضرابات عمال المناجم. وستجد دائماً ثمّة من يحذّر من أن الحروب الثقافيّة تجتاح المجتمع، والجبهات مشتعلة تنادي المقاتلين، لتتردد على أثرها أصوات قرع الطبّول عبر الفضاء السرمدي في ديمقراطيّة التجهيل المُتشظّي التي توفرّها مواقع التواصل الاجتماعي، لتلتهب المسألة وتستدعي مزيداً من ضجيج القبائل وصرخات الحمقى وتأوهات المغفلين.
لكن تحليلاً معمقاً لواقع المجتمع البريطاني، سواء في حياته السياسيّة أو منتجاته الثقافيّة أو أنساق الحياة اليوميّة في معظم أنحاء الجزيرة -ربما مع استثناء إيرلندا الشماليّة إلى حدّ ما بسبب خصوصيّة الصراع الكاثوليكي - البروتستانتي هناك الذي كلّما خبا أيقظته من غفلته جهات سياسيّة مستفيدة من تمديد أمد الخلاف، لكن تلك قصّة أخرى- سيخلص حتماً إلى أن ذلك التهويل بالحروب الثقافيّة ليس له رصيد من الواقع، وأن هنالك على الأرض نموذجاً ممتازاً لتعايش كتلة متباينة من البشر ذوي الأصول والأعراق والعقائد والمنابت المتباينة، في أجواء من تسامح عام وتقبّل للآخر. وذلك لا يعني بالضرورة حالة يوتوبيا نهائيّة تنعدم فيها الحوادث العنصريّة هنا أو هناك، أو ينتهي فيها مطلقاً استهداف بعضهم بالتمييز والعنف اللفظي، أو حتى الجسدي، بسبب هوياتهم العقائديّة أو العرقيّة أو الجندريّة، أو لا تنعزل فيها بعض الجيوب على أسس دينيّة متطرّفة. لكن تلك الحوادث والاستهدافات والمعتزلات تبدو من ندرتها ومحدوديتها، وانعدام تأثيرها في مجتمع يضم أكثر من 85 مليون إنسان، استثناءات تؤكد القاعدة، ولا تنفيها.
بالطبع، فإن الشعب البريطاني لم يأتِ من الفراغ، وتحمل أغلبيته البيضاء معها تراث حروب استعماريّة طويلة، ومذابح وسرقة موارد لم يكن لبريطانيا من دونها أن تبني مستوى الرفاه المادي الذي وصلت إليه، تماماً كما يتوارث المهاجرون إلى الجزيرة من كل أنحاء العالم ثقافاتهم القوميّة ولغاتهم وتقاليدهم وكتبهم المقدّسة. لكن بريطانيا في الخمسين سنة الأخيرة لم تعد مع ذلك تلك الإمبراطوريّة الفاجرة، وتسرّب إلى وعي ناسها شيئاً فشيئاً واقع الحياة الجديدة، حيث المملكة مجرّد عضو آخر في تجمع سياسي - اقتصادي هائل، يضم 27 أمّة أوروبيّة أخرى، وتتخذ فيه القرارات -روتينيّة أو مصيريّة لا فرق- بالإجماع التام. بل وشهدت عدة أجزاء من المملكة نهضة اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة، كنتيجة مباشرة لسياسات ذلك التجمع واستثماراته الموجهة نحو رفع سويّة العيش في الأقاليم الطرفيّة للبلاد التي طالما أهملتها لندن، ناهيك من شبكات الإنتاج المتكامل عبر القارة التي أنعشت قطاعات مثل التصنيع الدقيق والتكنولوجيّات المتقدّمة، أصبحت روافد رئيسة للاقتصاد البريطاني، بدلاً من القطاعات التقليديّة التي قضت عليها سياسات مارغريت ثاتشر النيوليبراليّة وحكومات خلفائها. كما صار مألوفاً أن ترى أوروبيين من خلفيّات متعددة يشاركون يداً بيد وبفاعليّة في إدارة المرافق الاقتصادية والتجاريّة والصناعيّة عبر البلاد، من شمالها إلى جنوبها.
وفي ذلك كلّه، نجت بريطانيا من الوقوع في مطبّ الحروب الثقافيّة التي هيمنت، وربّما أفسدت الحياة السياسيّة والاجتماعية للولايات المتحدّة. فعلى الجانب الآخر من الأطلسي، عملت فئات من النخبة الحاكمة عبر عقود على توظيف المحافظة الدينيّة الطابع وكراهيّة الآخر المختلف سلاح حرب ضد الأقليّات والفقراء والمهاجرين الملونين. لكن في بريطانيا، لا أحد يكسب أصواتاً اليوم عبر رواية نصوص من الكتاب المقدّس مثلاً، وليس هناك قادة مجتمع ذوو قيمة يدّعون أنهم مؤهلون للسلطة لأن الرّب باركهم، بينما حقوق الإجهاض والمثليين والتعبير السياسي والمساواة أمام القانون، والحريّات الفرديّة والحقوق الأساسيّة في التعليم والصحّة، رغم ما قد يشوبها من عيوب، عابرة لكل الحدود المتخيّلة، وتوحّد بين البريطانيين على الإطلاق، وهي بكل مقياس أفضل بسنوات ضوئيّة من مقابلها في الولايات المتحدة.
فمن أين إذن يستوحى أنصار «الحروب الثقافيّة» مادتهم؟ وما دافعهم وراء التداول بتلك العملة الزائفة؟ ومن الجهات التي تضع مكبرات الصوت أمام الأبواق الداعيّة للمواجهة؟
لقد ورث البريطانيّون المعاصرون رغماً عنهم نخبة تحكمهم أولدها تحالف قديم بين الأرستقراطية الثريّة والبرجوازيّة الصاعدة بجموح بعد الثورة الصناعيّة استمر إلى اليوم، وتفرّدت من خلال أساليب متنوعة سياسيّة وثقافيّة وقانونيّة واجتماعيّة بالهيمنة على الدّولة البريطانيّة، وحولتها إلى خادم لمصالحها الطبقيّة المحضة، ولو على حساب أغلبيّة البريطانيين العاديين. لكّن هذه الصيغة التي استمرت طويلاً، رغم تناقضها مع عصر الحداثة، بدأت الآن -وبشكل متزايد- بمواجهة نوع من أزمة حادة لتبرير وجودها ذاته، بسبب تراجع الانقسامات الثقافيّة (على المحور الأفقي، كما يحلو للبعض أن يسميها)، لمصلحة الوعي بالتراتبيات الطبقيّة (على المحور العمودي). وتلك بالطبع حالة تهديد وجوديّة تجد النخبة أن أمضى سلاح لمواجهتها ليس إلا إضعاف صيغة التسامح العابر لخطوط الهويّات المتخيّلة بين البريطانيين، وخلق «حروب ثقافيّة» بينهم تلهيهم عن مساءلة الممسكين بتلابيب الدّولة عمّا يفعلون. وهكذا، تخلق أزمات مفتعلة موجهة بعناية، مثل «بريكست» أو «الإرهاب الإسلامي» أو «الهجرة»، ويتولى كتاب وإعلاميّون منتفعون ترويج المبالغات بشأنها، مستفيدين من الهيمنة الكليّة على قنوات الخطاب العام التي يتعرّض لها البريطاني العادي خلال حياته اليوميّة، لتجد تلك المبالغات المغرضة جمهوراً لها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر غرف صدى تجمع بين الأنواع المختلفة من الحمقى وأنصاف المتعلمين والجهلة، فتتضخم وتكبر كما حمل كاذب يستعد الجميع للتعامل مع مولوده، إن ليس غداً فبعد غد.
لقد كشفت دراسات موثقة، أجراها خبراء العلوم الاجتماعية، أن أكثر المؤيدين بين البريطانيين لفكرة الانعزال عن أوروبا، وكراهيّة الإسلام، ومعاداة المهاجرين، لا يدركون أبعاد العلاقات الحاليّة بين الأوروبيين، وأفكارهم عن الإسلام نتاج صور إعلاميّة لا أساس واقعياً لها، وأن رهاب المهاجرين عندهم ليس مبنياً على أي فهم لديناميكيات المجتمع البريطاني الاقتصاديّة التي تحتاج لجهود هؤلاء، وتحصل عليها بثمن بخس. ومن الواضح أن هؤلاء في أغلبيتهم الساحقة أدنى تعليماً، ويحصلون على فرص عمل أقل من غيرهم، ونادراً ما يغادرون مكان ولادتهم، لكنهم يتعرضون إلى مادة موجهة من قبل منظومات الإعلام تستهدف جرّهم وقوداً لحروب هويات ثقافيّة ضد قبائل متخيّلة أخرى.
ها قد انتهت لعبة «بريكست»، وستتوالى ارتداداتها بالظهور تباعاً؛ تراجعات اقتصادية واجتماعيّة وثقافيّة ستنعكس أساساً على أسلوب حياة البريطانيين العاديين في المديين القصير والمتوسط على الأقل، الذين سيدركون -دائماً متأخرين- أن الانقسامات الحقيقيّة بينهم كانت في مكان آخر تماماً، وأن الحروب التي استدرجوا لخوضها لم تكن إلا خداع مرايا ودخان.
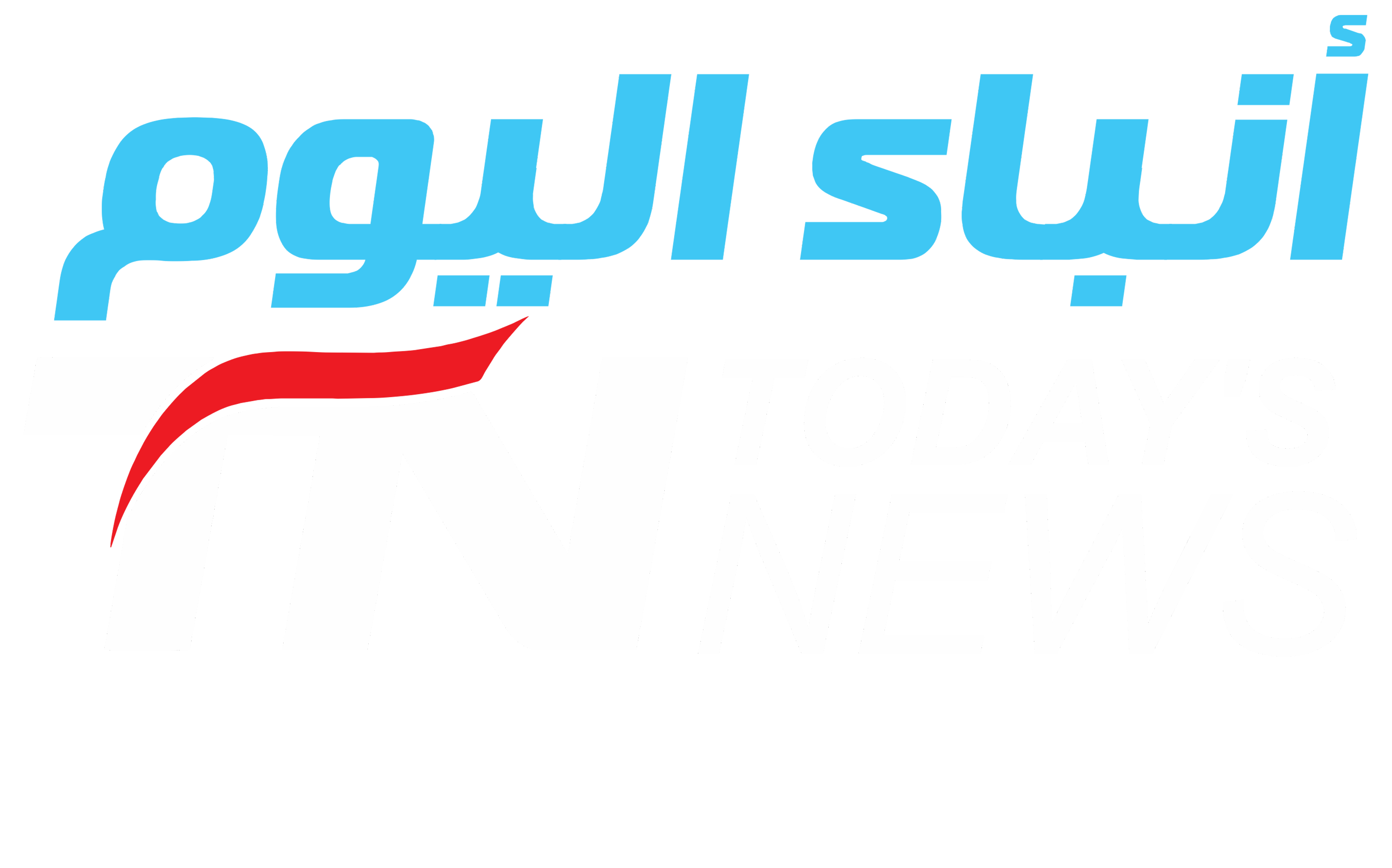


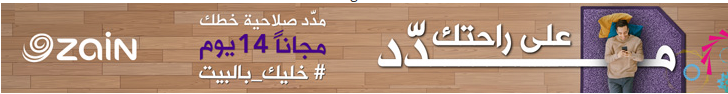


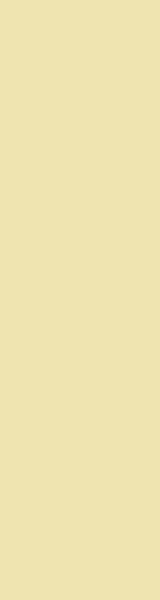












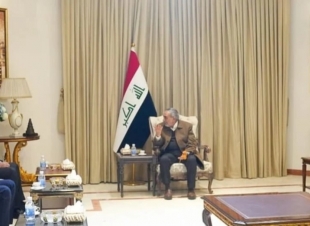






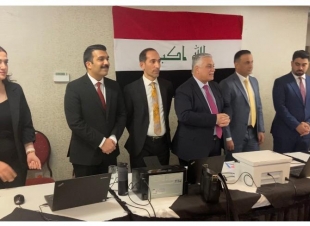


























 ">
"> ">
">




