تمرُّ على المرء مواقف ومحطات تشكّلُ منعطفًا في حياتهِ، وقد تُغيرُ حياتَهُ كليًا، وترسم ملامح جديدة في تكوين الشخصية، على جميع الأصعدة. كان يوم 12/حزيران/1981، أحد هذه المحطات أو المنعطفات، التي غيرت حياتي، فلم أعد بعد هذا اليوم كما كنتُ قبلَهُ، فالطالبُ الذي كان في مقاعد الدراسة يوم 11/حزيران من ذلك العام، أصبح في اليوم التالي معتقلًا سياسيًا، والإمتحان الجامعي الذي كان مُقررًا للطلبة في ذلك اليوم، لم يكن مقدرًا لـ (عمر البرزنجي) أداؤه، إذ كان بإنتظارهِ إمتحانٌ آخر أشد وأقسى. قمعٌ، وإرهاب .. مصادرةٌ للحريات .. نهجٌ إستبدادي، ودكتاتوريةٌ لم تُبقِ رأيًا مُخالفًا أو معارضًا إلا وأخفتهُ وقمعته … هكذا كان النظام السابق، خاليًا من العدل والرحمة، متسلطًا على رقاب العباد، لا يكادُ يخرجُ من حربٍ، حتى يدخلَ في حربٍ أخرى أشدُ فتكًا وتدميرًا، حتى كاد كُل بيتٍ عراقي لا يخلو من شهيدٍ أو مفقودٍ أو معتقل، وكنتُ أحد هؤلاء المعتقلين. قضيتُ في المُعتقل ستة أشهر، شاهدتُ فيها الكثير الكثير من رجال أمن النظام الذين إنهالوا على المُعتقلين السياسيين بالإهانات اللفظية والجسدية والنفسية، مما لا يتحملهُ بشر! إنني إذ أستذكرُ هذا اليوم، في الذكرى الثالثة والأربعين، وما يحمله من ذكرياتٍ أليمة، أستذكرُ في ذات الوقت الذكرى العاشرة لجريمة سبايكر التي إرتكبتها الجماعات الإرهابية الظلامية، التي مثلت إمتدادًا للإرهاب بأبشع صورهِ، وهي دليلٌ ملموس على إنعدام الضمير والإنحدار الأخلاقي. ختامًا أقول: إن كل ما تحملهُ تلك المواقف من ألمٍ وحزن، إلا أنها في ذات الوقت تدعو إلى الفخر والاعتزاز، فقد كانت معارضة النظام الدموي في ذلك الوقت ضربًا من ضروب الإنتحار، فلابد لمن عارضَهُ في ذلك الوقت أن يفخر ويعتز، وكذلك فإن المجد والخلود سيكون دائمًا وأبدًا لشهداء سبايكر الأبرار، وستبقى ذكراهم خالدةً في نفوس العراقيين وضمائرهم. عمر البرزنجي وكيل وزارة الخارجية 2024/6/12
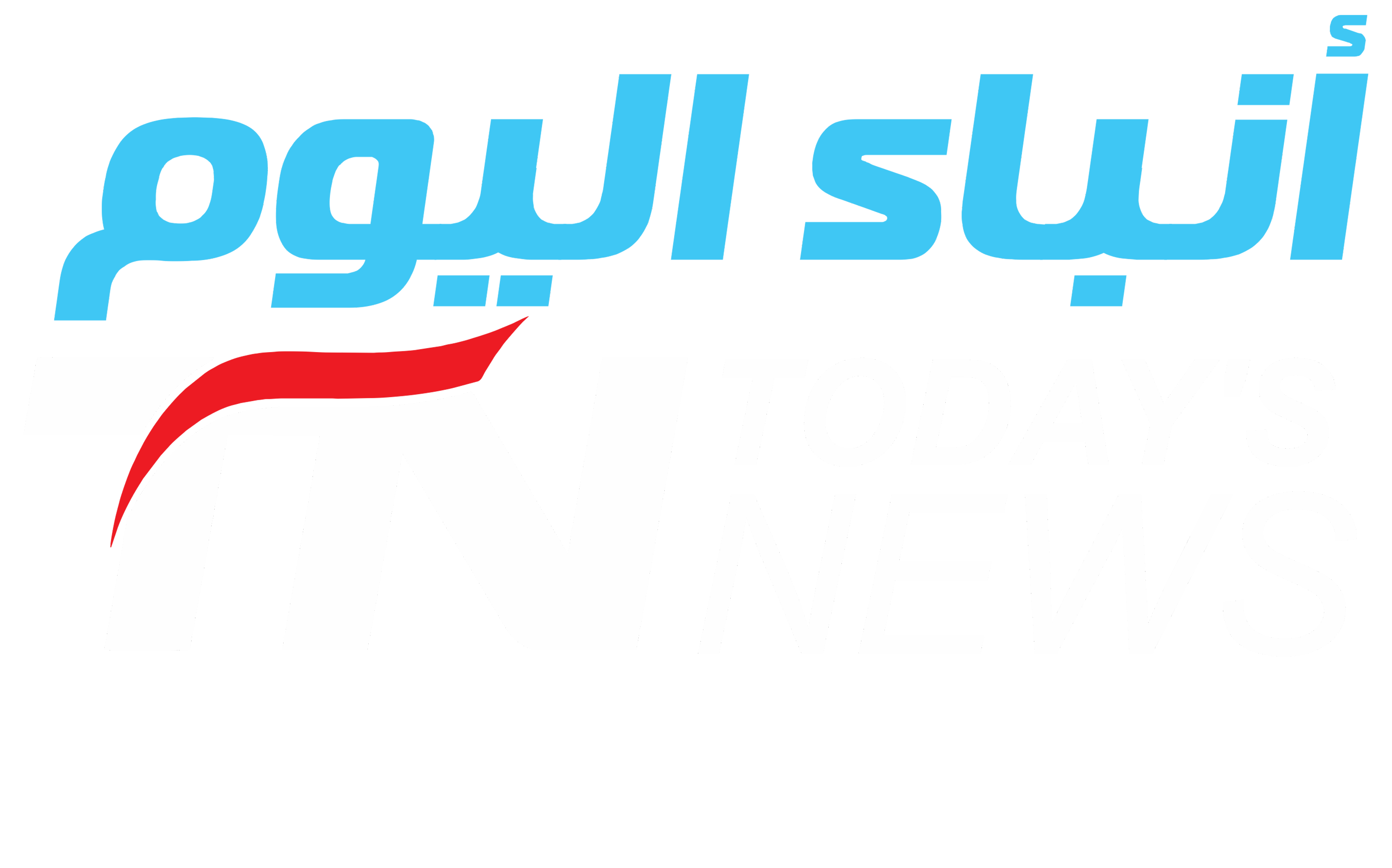


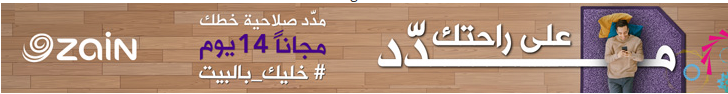


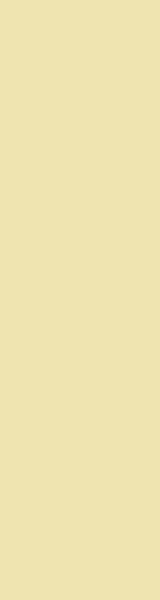


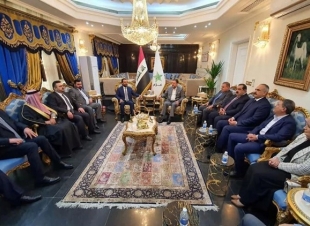

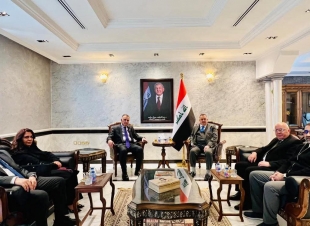
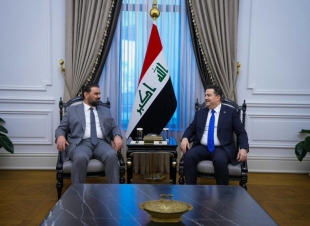

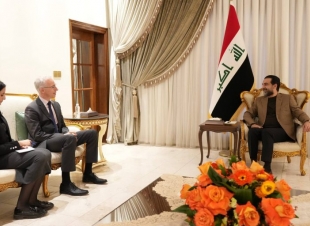








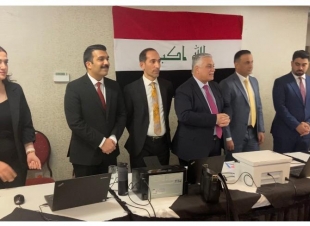


























 ">
"> ">
">




